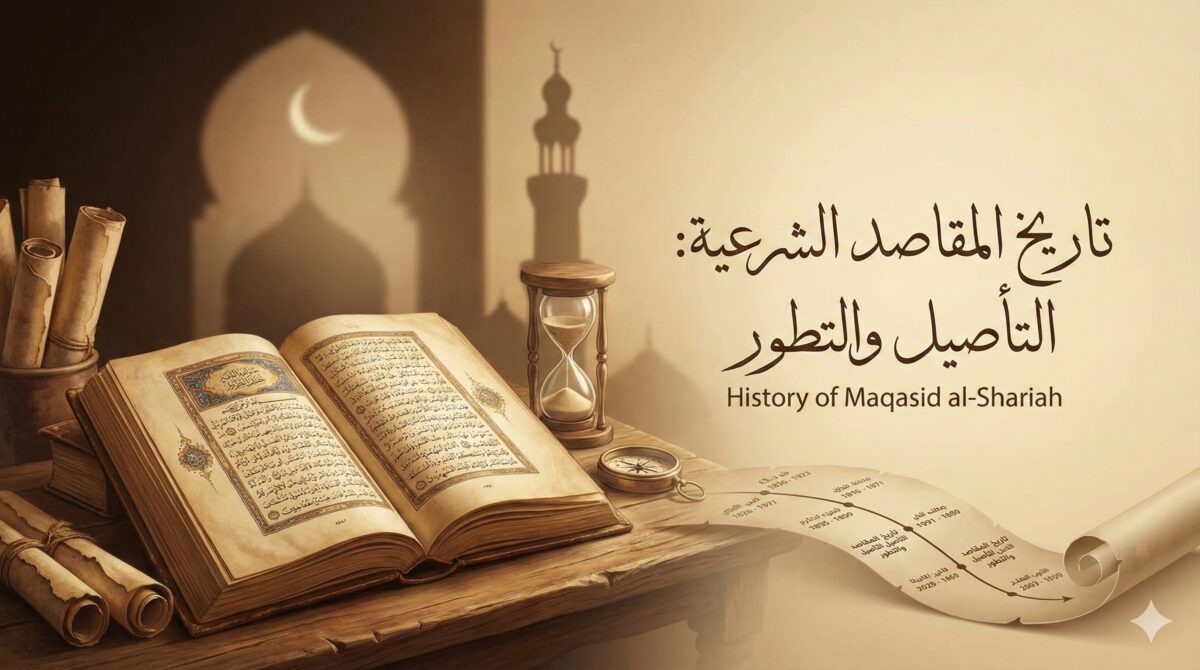أحاديث الربا: تصنيف الأحاديث النبوية في الربا وأحكامه

يُعدّ الربا من أشد المحرمات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وقد توعد الله آكله بحربٍ منه ورسوله. ورغم أن القرآن الكريم وضع القاعدة الراسخة لتحريم الربا، إلا أن السنة النبوية المطهرة جاءت لتفصّل أحكام الربا وتوضح صوره وتضع القواعد المانعة من الوقوع فيه. تتميز أحاديث الربا بالكثرة والتنوع، فهي لم تقتصر على نوع واحد، بل شملت التحذير العام، وبيان ربا الديون (ربا الجاهلية)، وتفصيل ربا البيوع (الربا الخفي) في أصناف محددة.
نظراً لهذا التنوع، يهدف هذا المقال إلى تقديم تصنيف منهجي للأحاديث النبوية في الربا، معتمدين في هذا التقسيم على الدراسة القيمة التي قدمها الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه “الجامع في أحكام الربا”، سنقوم بتصنيف الأحاديث ضمن أربعة أصناف رئيسية واضحة، مما يساعد القارئ على بناء فهم متكامل ومنظم لأدلة تحريم الربا، وكيف عالجت السنة النبوية هذا الباب العظيم، بدءاً من التحذير العام وصولاً إلى أدق تفاصيل المعاملات اليومية.
الأصناف الأربعة لأحاديث الربا
- الصنف الأول: أحاديث في تحريم الربا بوجه عام، واعتباره من الكبائر والتركيز على بشاعة آكله.
- الصنف الثاني: أحاديث تتعلق بالربا، لا بمعناه الاصطلاحي، بل بمعناه اللغوي أو الشرعي العام، وهو الزيادة، والمراد الزيادة المحرمة. وإطلاق الربا عليه مجاز، شرعاً ولغة وعرفاً [1].
- الصنف الثالث: أحاديث في النهي عن ربا الجاهلية (ربا الديون)، أو الربا الجلي، حسب اصطلاحات العلماء.
- الصنف الرابع: أحاديث في النهي عن ربا البيوع، أو الربا الخفي.
الصنف الأول: أحاديث التحريم العام للربا
تركز هذه الأحاديث على شناعة الربا واعتباره من الموبقات، دون الدخول في تفاصيل الأنواع.
- نهى النبي عن (…) آكل الربا وموكله. (رواه البخاري ٧٨/٣)
- ولعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء». (رواه مسلم ١١٠/٤، وللبخاري نحوه ٧٧/٣)
- الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه [2]، وإن أربي الربا عرض الرجل المسلم [3]. (رواه ابن ماجه مختصراً ٧٦٤/٢، والحاكم بتمامه وصححه على شرط الشيخين ٣٧/٢)
الصنف الثاني: أحاديث في معنى الربا اللغوي (الزيادة المحرمة)
هذه الأحاديث تصف معاملات محرمة فيها “زيادة” أو “غبن” وسُميت ربا على سبيل المجاز لخطورتها.
- “غبن المسترسل ربا” (رواه البيهقي ٣٤٩/٥، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وإسناده جيد، كما قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٠٠/٤).
المسترسل هو المشتري الذي ينبسط إلى البائع (أو العكس)، ويستأنس به ويأمنه، ويكون سهلاً (رخوًا) معه، طبعاً له، وجاهلا بالسعر، وهو خلاف المماكس. فالمسترسل بعبارة أخرى هو بائع أو مشتر، جاهل بالسعر، لا يماكس صاحبه، بل يقول: بعني أو اشتر مني، كما تبيع أو تشتري من الناس.
- “الناجش آكل ربا ملعون” (رواه الطبراني في الكبير، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ٦٧٨/٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٥٧١/٦).
قال البخاري: (الناجش آكل ربا خائن) [4]. الناجش لغة هو الذي ينفر الصيد، ويستثيره من مكانه، ليصاد. والمقصود به هنا هو المزايد الصوري، الذي يتظاهر بأنه مشتر، ويزيد في الثمن، أو يمتدح السلعة، ليغر المشترين الحقيقيين، ويزاحمهم، ويخدعهم، ويثير الرغبة عندهم والحماسة، فيدفعوا في السلعة أو الخدمة أكثر من ثمنها، وذلك سواء كان متواطئاً مع البائع أو غير متواطئ [5].
وربما يدخل فيه البائع نفسه، إذا أخبر المشتري بأنه اشترى السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها به، أو إذا مدح سلعته بما ليس فيها بالدعاية الكاذبة، والإعلان المضلل. كما قد يدخل فيه المشتري إذا ذم سلعة البائع وعابها كذباً، أو من يتواطأ مع المشتري فينقص في الثمن، أو يكف عن مزاحمته في المزايدة، ويخدع البائع.
وجماع المعنى هو التأثير الخادع على الأسعار، باتجاه الصعود لمصلحة الباعة، أو باتجاه الهبوط لمصلحة الشارين. فالنجش تأثير ومخادعة.
- عن رافع بن خديج أنه زرع أيضاً، فمر به النبي ﷺ، وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر. فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك. (رواه أبو داود في كتاب البيوع ٢٦١/٣).
والمقصود هنا هو أن تقديم الأرض وحدها مزارعة، أي على حصة من الناتج، لا يجوز. ولعل الذين اشترطوا أن يقدم رب الأرض البذر قد استندوا إلى هذا الحديث. ولكن إسناد الحديث فيه كلام [6]، فلا أرى الأخذ به رواية ولا دراية [7]، وسنعود إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الباب السابع، لدى الكلام عن أجر الأرض وفائدة القرض.
- “إن أربي الربا عرض الرجل المسلم.” (وقد تقدم في أمثلة الصنف الأول مع شرحه).
- “من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية، فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا.” (رواه أحمد في مسنده ٢٦١/٥).
والمقصود بالشفاعة هنا هو توسط المسلم لأخيه المسلم لإيصاله إلى حقه بجلب نفع له أو دفع ضر عنه. قال تعالى: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) [سورة النساء: الآية ٨٥]. وقد بين العلماء أن الشفاعة من المصالح العامة التي يجب القيام بها فرضاً على الأعيان، أو على الكفاية، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها [8].
الصنف الثالث: أحاديث تحريم ربا الديون (ربا الجاهلية)
هذا الصنف يركز على النوع الذي كان شائعاً في الجاهلية، وهو ربا النسيئة(التأخير)، أي زيادة الدين مقابل زيادة الأجل. إن أحاديث هذا الصنف ليست كثيرة، لأن ما جاء في القرآن كان كافياً لفهم المخاطبين بالتشريع. ومثال هذا الصنف:
- قوله ﷺ في خطبته الأخيرة بحجة الوداع: “ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». (رواه البيهقي ٢٧٥/٥).
وفي رواية: “وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب وإنه موضوع كله…”. (رواه البيهقي ٢٧٥/٥).
وفي رواية: “… وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله…”. (من سيرة ابن هشام ٦٠٣/٢).
وفيه دليل على حرص النبي ﷺ على المحافظة على مطابقة القول الفعل بالنسبة له ولقرابته، وأن الناس في أحكام الله سواء [9]، وفي ذلك أسوة للحكام والمفتين والقضاة والدعاة والخطباء والوعاظ والكتاب والعلماء والفقهاء…
- “إنما الربا في النسيئة.” (صحيح مسلم ١٠٩/٤)
- “لا ربا إلا في النسيئة.” (صحيح البخاري ۹۸/۳)
- “ولا ربا فيما كان يداً بيده.” (صحيح مسلم ١٠٩/٤)
الصنف الرابع: أحاديث ربا البيوع (الربا الخفي)
هذا الصنف هو الأكثر تفصيلاً ويضع قواعد بيع الأصناف الربوية (الأموال الستة)، وهو كثير ويقارب العشرين حديثاً[10]، نختار منها:
- “الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيده.” (رواه مسلم ٩٨/٤)
الذهب بالذهب: الباء هنا تفيد المقابلة، فتدخل على الأعواض، أي الذهب مقابل الذهب (عوضه، بدله).
زاد: أعطى الزيادة. استزاد: طلب الزيادة. أربي: فعل الربا المحرم.
وفيه دليل على تعيين التقدير بالوزن، لا بالخرص والتخمين. قال العلماء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل)، فلا يجوز جزاف بموزون او مكيل (مجهول بمعلوم) ولا جزاف بجزاف (مجهول بمجهول)، فحرمة التفاضل تقتضي معلوماً بمعلوم.
مثلاً بمثل: أي دون اختلاف في النوع (المثل: الشبه والنظير).
سواء بسواء: أي دون اختلاف في القدر (الوزن أو الكيل).
يداً بيد: أي بدون تأخير، ولا تأجيل أي مع التقابض (= التناقد) في المجلس، من يدك إلى يده، ومن يده إلى يدك.
فهذه ثلاثة أوجه للتساوي: التساوي في النوع، والتساوي في المقدار، والتساوي في الزمن.
- “الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء». (رواه البخاري ٨٩/٣)
هاء وهاء يعني مقابضة في المجلس. وهو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه ما في يده. وهو مثل قوله: يداً بيد. يقال للواحد هاء، وللاثنين: هاؤما، وللجمع هاؤم. قال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة [11].
- عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: “الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربي. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يداً بيد، وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يداً بيد، وأما نسيئة فلا.” (رواه أبو داود ٢٤٨/٣)
مدي بمدي: مكيال بمكيال. (في جامع الأصول ٥٥٤/١: مدين بمدين، وهو خطأ مطبعي). المدي: ج امداء مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكاً… (إلخ) [12].
التبر، العين: قال الخطابي: التبر قطع الذهب والفضة، قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانير، واحدتها: تبرة. والعين المضروب من الدراهم أو الدنانير. وقد حرم رسول الله ﷺ أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب… وفيه دليل على أن الذهب والفضة ربويان سواء كانا نقوداً مضروبة أو مجرد سبائك.
- عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: “أكل تمر خيبر هكذا؟” فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال النبي: “لا تفعل. بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك». (متفق عليه البخاري ١٠٢/٣، ومسلم ١٠٥/٤).
الجنيب: الطيب، أو الصلب…
الجمع: الرديء، أو الخلط من التمر…
وقال في الميزان مثل ذلك: أي قال فيما كان يوزن، إذا بيع بجنسه، مثل ما قال في المكيل، إنه لا يباع متفاضلاً.
وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري… فقال رسول الله ﷺ: “ويلك أربيت. إذا أردت ذلك، فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت.” (جامع الأصول ٥٤٦/١ – ٥٤٧).
- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نُرْزَق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي: “ولا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم”. (رواه البخاري ٧٦/٣).
- عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر التي لا يُعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر» (رواه مسلم ٢٠/٤).
الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صبر.
- عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه… قال: إني كنت اسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام، مثلاً بمثل»، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يضارع). (رواه مسلم ١٠٤/٤) [13].
- عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تباع حتى تفصل). (رواه مسلم ١٠١/٤).
فصلتها: ميزت خرزها من ذهبها.
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز». (متفق عليه البخاري ٩٧/٣، ومسلم ٩٤/٤).
مثلاً بمثل: متساويين نوعاً (عياراً).
ولا تُشفوا: لا تفاضلوا بينهما كماً (مقداراً).
الغائب: ما غاب عن مجلس البيع، مؤجلاً كان أو لا.
الناجز: الحاضر.
- “نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا». (رواه البخاري ۹۸/۳).
- “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم». (رواه البخاري ۹۷/۳).
قال أبو سعيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “الذهب بالذهب مثلاً بمثل والورق بالورق مثلاً بمثل”. (رواه البخاري ۹۷/٣).
الورق: الفضة المضروبة دراهم.
- عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف… فكلاهما يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً». (رواه البخاري ۹۸/۳).
- عن مالك بن أوس… وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: “الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء…”. (رواه البخاري ۹۷/۳).
قال عمر بن الخطاب: “… وإن استنظرك (طلب منك إنظاره) إلى أن يلج بيته، فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء». (رواه في الموطأ – جامع الأصول ٥٦١/١).
الرماء هو الربا.
يقول أبو المنهال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله، فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: “وإن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح”. (رواه البخاري ٧٢/٣).