“علم الاكتناه” العربي الإسلامي: نحو وعي حضاري بجوهر المخطوط
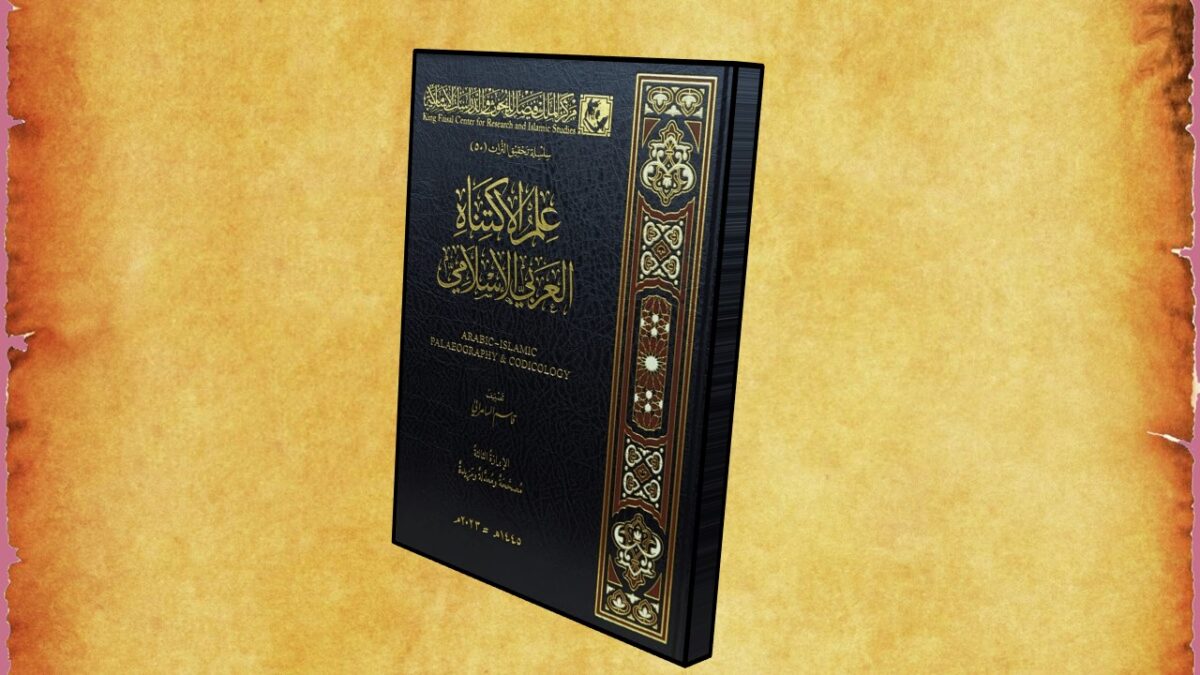
هل يمكن أن نقرأ المخطوط كما نقرأ روح أمة؟ في زمن تهمّشت فيه الذاكرة الورقية أمام شاشات التقنية، ينبثق علم الاكتناه كصيحة وعي جديدة أطلقها الدكتور قاسم السامرائي، مُعيدًا للمخطوط العربي مكانته ككائن ثقافي لا كوثيقة ماضوية فقط، وذلك في كتابه بعنوان “علم الاكتناه العربي الإسلامي”.
علم الاكتناه العربي الإسلامي ليس مجرد حقل معرفي جديد، بل منظور ثوري ينظر إلى المخطوط بوصفه بنية حية، تحتوي على فن الخط، وأسرار الأحبار، وصنعة الورق، وتوثيق المِلكيات، وعلامات النسّاخ، وتاريخ الزخرفة.
هذا الكتاب يؤسس لعلم جامع، يُعيد للمخطوط حضوره بوصفه مرآة حضارية، لا تقرأ فحسب، بل تُستكشَف وتُكتنَه، مُبرزًا العلاقة بين النص والمواد والتاريخ والوظيفة الجمالية والاجتماعية.
فإذا كنت باحثا في التراث؟ أو محقق نصوص؟ أو مهتم بتاريخ الكتاب العربي؟ فهذا المرجع التأسيسي الفريد يهمك، لما يتضمنه من بناء وعي جديد حول ما تحمله المخطوطات من ذاكرة وهوية.
في زمن يتسارع فيه الرقمي على الورقي، ويتوارى فيه فن المخطوط خلف شاشات الحاسوب، ينبري الدكتور قاسم السامرائي لإحياء علم قلّ من تناوله بالشمول والدقة: علم الاكتناه، وهو “علم دراسة المخطوط من حيث مكوناته المادية والفنية والرمزية”، لا باعتباره نصًا فقط، بل ككائن ثقافي له بنية وصنعة وتاريخ.
لماذا علم الاكتناه؟ وما هو علم الاكتناخ؟
“علم الاكتناه” هو علم دراسة الكتاب المخطوط أو صناعته، ودراسة أصول الخط العربي، وإرساء قواعد فن تحقيق النصوص، وأصول الفهرسة، بما في ذلك: صناعة الأحبار، وفن النِّساخة، والتجليد، والتذهيب، وصناعة الرقوق، والجلود والكاغد. وما يتبع ذلك من فنون مثل: حجم الكراسة، ونظام الترقيم، والتعقيبات، والسماعات، والقراءات، والإجازات، والمقابلات، وتقييدات التملُّك، وتقييدات الوقف، وما يظهر في نهاية المخطوطة من اسم المؤلف، واسم الناسخ، ومكان وتاريخ النسخ، وما إلى ذلك.
في كتابه الصادر عام 2023 تحت عنوان “علم الاكتناه العربي الإسلامي”، يخوض الدكتور قاسم السامرائي غمار تأسيس حقل معرفي جديد في الدراسات التراثية، وهو “علم الاكتناه”، بوصفه علمًا جامعًا لعلوم الخط والمخطوط، وفن التحقيق، وتقنيات النسخ، وأساليب الفهرسة، وفنون الزخرفة، وصناعة المواد الورقية والجلدية، وتوثيق ملكية النصوص وتداولها. لا يكتفي السامرائي بتأريخ هذه الفنون أو وصفها، بل يسعى إلى اكتناهها، أي إدراك حقيقتها الباطنة، وتقديمها كمنظومة ثقافية متكاملة. هذا الكتاب لا يعيد فقط الاعتبار للمخطوط العربي بوصفه وعاء علم، بل أيضًا بوصفه مرآة لذوق الحضارة الإسلامية وذاكرتها المادية والروحية.
في مقدمة الكتاب، يُؤصل المؤلف لمصطلح “الاكتناه” على أنه تجاوز السطح إلى الجوهر، وعلى هذا يبني علمًا يُعنى بتشريح المخطوط العربي الإسلامي كما يتعامل المؤرخ مع الوثائق، أو المحقق مع النصوص، أو الأثري مع القطع النادرة.

في الفصل الأول “نشأة علم الاكتناه وحدوده المعرفية” يُعرّف المؤلف علم الاكتناه بأنه فرع مركب يتقاطع مع:
- علم الخط العربي وتطوره التاريخي
- علم الكتاب المخطوط (Codicology)
- فن تحقيق النصوص وضبط الأصول
- علم المواد: صناعة الورق، الحبر، الجلد
- الدراسات الببليوغرافية والفهرسة التقليدية
ويُبيّن الدكتور السامرائي أنّ التراث الإسلامي عرف هذا العلم ضمنًا من خلال جهود المحققين، والنساخ، والفهارسية، والوراقين، ولكن لم يُصَغ كمجال معرفي مستقل إلا في العصر الحديث، تأثرًا بتطورات علم المخطوط الغربي، مع حفاظه على خصوصيته الإسلامية.
من المصطلح إلى المنهج: تأصيل علم الاكتناه
في مستهل الكتاب، يعرض المؤلف لمفهوم “الاكتناه” باعتباره أكثر من مجرد توصيف للمخطوط، بل هو ولوج إلى جوهره، كما يُكنه الإنسان الشيء حين يدرك باطنه ويستبطن معناه العميق. بناءً على ذلك، يقترح “علم الاكتناه” كعلم يُعنى بفهم الكتاب المخطوط في بنيته، ومادته، وتاريخه، وصناعته، وتداوليته، ووظيفته الحضارية. ويؤكد أن هذا العلم، وإن لم يُصَغ كمصطلح صريح في التراث الإسلامي، إلا أن ممارساته كانت حاضرة لدى العلماء والمحققين والوراقين الذين تعاطوا مع المخطوط ككائن حي، لا كمجرد حبر على ورق.
يربط المؤلف هذا الحقل العلمي بنظيره الغربي المعروف باسم Codicology، لكنه يُصر على استقلالية “علم الاكتناه العربي الإسلامي” بما له من خصوصية حضارية وتجذر في البيئة الثقافية الإسلامية التي تجمع بين النص والقداسة والجمال والصنعة.
الخط العربي والمخطوط: من الكتابة إلى الجمالية
يفرد المؤلف فصلاً طويلًا للحديث عن الخط العربي بوصفه البنية التحتية الأولى للمخطوط، فيستعرض تطور الخطوط العربية بدءًا من جذورها النبطية، ومرورًا بالحجازي والكوفي، ثم تفرعات النسخ والثلث والمغربي والفارسي. يولي الكتاب عناية خاصة للعلاقة بين تطور الخط العربي وبين وظيفة المخطوط، فالخط لم يكن يومًا وسيلة تقنية فحسب، بل أيضًا أداة تعبير فني وروحي.
ويُبرز المؤلف كيف أن جمال الخط انعكس على تصميم صفحات المخطوط، وعلى معمار النص، وعلى اختيار الأحبار، بل وحتى على طريقة ترقيم الصفحات وتنسيق العناوين. ويستعرض في هذا السياق نماذج بصرية نادرة من المخطوطات القرآنية والفقهية والطبية التي يتجلى فيها التكامل بين الخط والزخرفة كمظهر من مظاهر التدين الجمالي في الإسلام.
في الفصل الثاني “تطور الخط العربي وأثره في المخطوط”، يتناول هذا الفصل الخط العربي من الجذور النبطية إلى التبلور في الخط الحجازي ثم الكوفي، حتى نشوء خطوط مثل النسخ، والثلث، والتعليق، والديواني، والمغربي. ويربط المؤلف بين كل مرحلة تاريخية وتطورها في شكل المخطوط من حيث:
- نمط الكتابة (بلا نقط، ثم بالنقط والشكل)
- أدوات الكتابة (القلم، القصبة، أنواع الأحبار)
- تغير الأحجام والزخرفة تبعًا للوظيفة (قرآنية، فقهية، سلطانية)
ويُبرز أن الخط ليس أداة توصيل فقط، بل فن تعبيري ذو بُعد جمالي وصوفي، خصوصًا عند المتصوفة.
البنية المادية للمخطوط: من الرق إلى الكاغد
ينتقل الكتاب في فصوله التالية إلى ما يسميه المؤلف “جسد المخطوط”، حيث يتناول المواد الخام التي صُنعت منها المخطوطات العربية، من جلود الحيوانات التي كانت تُعالج بأساليب دقيقة لتحويلها إلى رقوق، إلى الورق السمرقندي والمصري والأندلسي، مع بيان خصائص كل نوع وميزاته وسلبياته.
كما يعرض المؤلف تقنيات صناعة الأحبار، ويُميز بين الأحبار النباتية والمعدنية، ويشرح كيفية اختبار جودتها، ويبيّن أسباب تغير لونها أو تحللها بمرور الزمن. ويتناول أدوات الكتابة (القصبة، السكين، المِسطرة)، وتقنيات التجليد والتذهيب التي حولت بعض المخطوطات إلى تحف فنية مذهّبة تسر الناظرين.
في الفصل الثالث وهو بعنوان “المواد المكوِّنة للمخطوط”، ينتقل المؤلف إلى بُنية المخطوط المادية، ويفصل في:
- الرقّ والجلد: استخدام جلود الأغنام والبقر والماعز، وكيفية معالجتها بالرماد والملح والتجفيف.
- الورق (الكاغد): الورق السمرقندي، والصيني، والمصري، وخصائص كل نوع.
- الأحبار: النباتية والمعدنية، ومزاياها ومشاكلها (التحلل، السواد، الطمس).
- التذهيب والتزيين: رمزية الزخارف ودلالات الألوان، ومدارس الزينة (المملوكية، الأندلسية، الصفوية).
يُثبت المؤلف أن دراسة هذه العناصر تكشف ليس فقط عن مستوى الفن والصنعة، بل عن الذوق الحضاري والقيمي للمجتمعات الإسلامية.
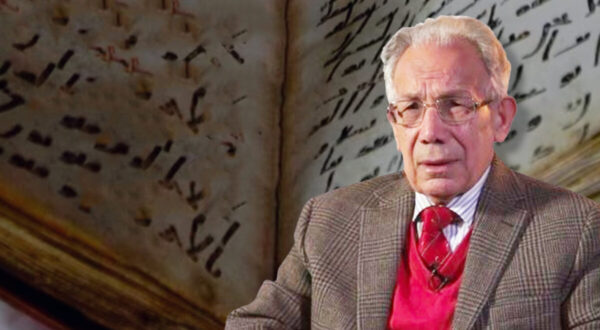
ولعل من أهم ما يقدمه الكتاب في هذا الباب هو إظهار كيف أن كل عنصر مادي في المخطوط – الورق، الحبر، التجليد – يحمل دلالة ثقافية وحضارية تكشف عن بيئة الإنتاج، وطبقة المستخدمين، وهدف المخطوط.
النساخ والفهرسة: الكُتّاب المجهولون وبناة الذاكرة
يعرض الدكتور السامرائي في فصل خاص لفئة طالما أُهملت في دراسات المخطوط: الناسخون. لا يراهم مجرد كتبة، بل شركاء فعليون في إنتاج المعرفة، إذ كانوا يتقنون الخط، ويضبطون النصوص، ويثبتون التعقيبات والتصحيحات، ويراعون أصول الوقف والتنقيط والتهميش.
ويستعرض المؤلف شواهد متعددة من كتب التراث على آداب النسخ، مثل دعاء الناسخ، أو إثبات اسم المؤلف ومكان النسخ وتاريخه، أو تعليقاته النقدية على النص، أو حتى أقواله الشخصية التي كان يضمنها نهاية النسخ. ويُبين كيف أن هذه البيانات أصبحت مصادر ثمينة للمؤرخين والباحثين في ما يُسمى اليوم علم الأرشفة الإسلامية.
في هذا الفصل الرابع بعنوان “فن النساخة وآداب الناسخ” يُفرد هذا الفصل للناسخ، باعتباره الوسيط الحي بين المؤلف والمتلقي، ويتناول فيه:
- أخلاقيات النسخ: الدقة، الأمانة، التواضع، الدعاء للمؤلف والقارئ.
- مهارات الناسخ: إجادة الخط، الترقيم، وضع الهوامش، ضبط القراءة.
- مظاهر التوثيق: ذكر اسم الناسخ، التاريخ، مكان النسخ، الصلوات، الأدعية، وعبارات مثل: “تم بحمد الله”، “حرره العبد الفقير إلى رحمة ربه”.
وينقل عن كتب التراث شواهد مهمة حول مواقف النساخ، منها ما جاء في “كشف الظنون” و”الفهرست” و”الذريعة”.
أما الفهرسة، فهي في نظر المؤلف فن إسلامي أصيل، لا يُختزل في قوائم الكتب، بل يتعدى ذلك إلى “تقييدات” دقيقة تُسجل أسماء المالكين والوقفيات والسماعات والإجازات. كل ذلك جعل من المخطوط العربي وثيقة متعددة الطبقات تصلح لأن تكون مادة للبحث في الفقه والاجتماع والاقتصاد والتاريخ.
وفي الفصل الخامس بعنوان “الفهرسة وتقاليد التوثيق” يحلل المؤلف تطور علم الفهرسة في التراث الإسلامي، مستعرضًا:
- جهود أعلام مثل ابن النديم، والزركلي، وحاجي خليفة
- أنواع الفهارس: الموضوعية، الاسمية، الأبجدية، الزمنية
- تقاليد مثل التعقيبات، السماعات، القراءات، الإجازات، التملّك، الوقف
ويبيّن أن كل هذا يُسهم في تحقيق النص وفهم سياقه وموثوقيته، كما أن “الوقف” و”التملّك” يحوّلان المخطوطة إلى وثيقة قانونية اجتماعية.
التحقيق بين التراث والمنهج
في الفصل السادس وجاء بعنوان “مناهج تحقيق النصوص” يناقش هذا الفصل مبادئ التحقيق في المدرسة العربية الإسلامية، ويُفرّق بين:
- التحقيق الكلاسيكي: قراءة النص وفهمه وضبطه بالرجوع إلى الأصول
- التحقيق المقارن: اعتماد النسخ، والمقابلة، وإثبات الاختلافات
- التحقيق العصري: استخدام الكوديكولوجيا، التحليل المخبري، الوسائل الرقمية
كما ينتقد المؤلف بعض مناهج التحقيق الحديثة التي تتجاهل السياقات الحضارية للنصوص، ويدعو إلى “تحقيق بالمشاركة” بين اللغوي، والمؤرخ، والفيزيائي، والخطاط.
في هذا الفصل المهم، يُقارن الدكتور السامرائي بين مناهج التحقيق التراثية والمناهج الحديثة. فيعرض منهج المحققين الكلاسيكيين الذين كانوا يعتمدون على المقابلة بين النسخ، وضبط الألفاظ، وفهم السياق اللغوي، وربط المتن بالشروح والتعليقات. ثم ينتقل إلى مناهج التحقيق الغربي التي تستخدم وسائل علمية حديثة مثل التحليل الكيميائي للأحبار، أو التأريخ بالكربون المشع، أو برامج OCR للتعرف البصري على الخط.
لكن المؤلف، رغم تقديره للأدوات الحديثة، يحذر من “التحقيق التقني المجرد”، ويدعو إلى تحقيق شامل يدمج بين اللغة، والتاريخ، والمادية، والسياق، وهو ما يتيحه علم الاكتناه. ويقترح إنشاء لجان متعددة التخصصات لتحقيق المخطوطات الكبرى على غرار الفرق الأوروبية.
المخطوط كوثيقة حضارية
في الخاتمة، يرتقي الدكتور السامرائي برؤيته من المستوى الفني إلى المستوى الحضاري، مؤكدًا أن المخطوط العربي الإسلامي ليس مجرد أثر تاريخي، بل مرآة لروح الأمة وذاكرتها الحية. فهو يحمل آثار المدارس العلمية، والمذاهب الفقهية، والصراعات الفكرية، وحالات الترف الفني، وحتى أوضاع الورّاقين والأسواق الثقافية في بغداد ودمشق والقاهرة وفاس وقرطبة.
ففي الفصل السابع بعنوان “القيمة الحضارية للمخطوط” يسلط المؤلف الضوء على كون المخطوط العربي ليس وعاء معرفة فقط، بل هو:
- مرآة للذوق الفني الإسلامي
- دليل على شبكات التعليم والتداول
- وثيقة عن الحياة الاجتماعية والوقفية والسياسية
- حامل لتراث الأمم الإسلامية المتعددة (العربية، الفارسية، التركية، الأمازيغية، الهندية)
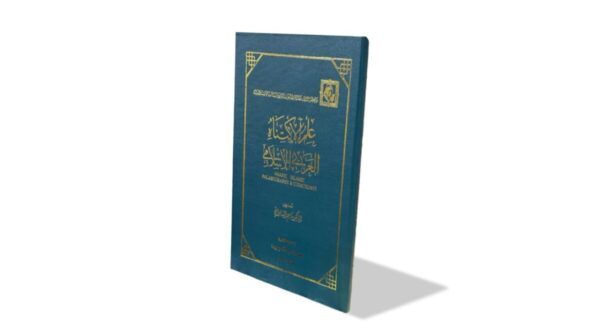
ويعتمد في ذلك على شواهد من مخطوطات قرآنية، طبية، فقهية، صوفية محفوظة في مكتبات مثل المكتبة الظاهرية، ودار الكتب المصرية، ومكتبة برلين.
ويشدد المؤلف على أن إعادة إحياء “علم الاكتناه” لا يعني فقط دراسة ما كتبه السلف، بل بناء وعي جديد بالمخطوط كمصدر لإعادة قراءة تاريخنا، ووسيلة لصياغة مستقبل ثقافي متجذر.
في الختام: دعوة إلى الاعتناء بالكنوز الورقية
في خاتمة الكتاب، يدعو المؤلف إلى:
- استقلال علم الاكتناه كعلم أكاديمي له أدوات ومناهج خاصة
- إنشاء معاهد متخصصة تُعنى بالمخطوط من حيث صناعته وفهرسته وتحقيقه
- التفاعل مع مناهج codicology الغربية مع مراعاة الخصوصية الإسلامية
- تكوين جيل من الباحثين يُدرك البنية الحضارية للمخطوط، وليس فقط نصّه
ويختم بعبارة بليغة: “كل مخطوطة تحمل روحًا… لا بد من اكتناهها، لا قراءتها فقط.”
نحو تأسيس علم الاكتناه
وعموما، يمثل هذا الكتاب نداءً أكاديميًا صريحًا لإعادة الاعتبار للمخطوط العربي، لا بوصفه مادة تراثية ميتة، بل ككائن حي يحمل روح الحضارة الإسلامية. “علم الاكتناه العربي الإسلامي” ليس مجرد دراسة أكاديمية، بل مانيفستو حضاري يضع بين أيدينا أدوات جديدة لفهم تراثنا، وفك رموزه، واستخراج كنوزه. هو كتاب تأسيسي جدير بأن يُدرّس في كليات التراث والمكتبات والتاريخ الإسلامي، وجدير بأن يُفتح به باب بحث علمي عربي يعيد رسم خريطة المعرفة المخطوطة من منظور إسلامي أصيل.
يُمثل كتاب “علم الاكتناه العربي الإسلامي” إضافة نوعية في ميدان الدراسات التراثية والمخطوطات، إذ يجمع بين:
- الرؤية الموسوعية: حيث يغطي علومًا عديدة بطريقة تكاملية
- اللغة العلمية المتزنة: لغة دقيقة لكن غير معقدة، تخاطب المتخصص والمهتم العام
- الاستناد إلى مصادر تراثية وأدوات حديثة: يجمع بين الموروث والمناهج الغربية دون تفريط أو استعلاء
ويُعد الكتاب مرجعًا لا غنى عنه للباحثين في المخطوط العربي، علم التحقيق، التراث الإسلامي، وتاريخ الكتاب.




