إشكالية المنظومة التربوية العربية المعاصرة
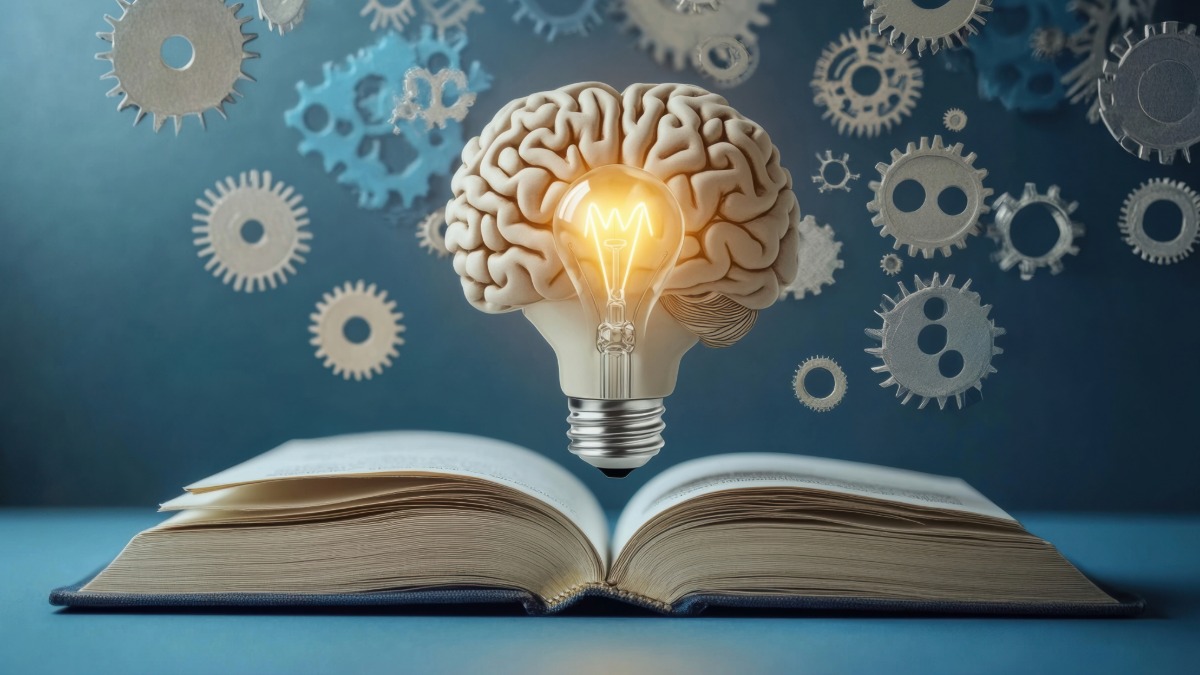
يتعين علينا الوقوف على جوهر أزمة المنظومة التربوية في العالم العربي والإسلامي، والمتمثلة في مخرجات المتعلمين والمثقفين، الذين ترسّخت فيهم الثقافة الغربية، بوصفها الثقافة العليا، في مقابل جهل شديد بالرصيد الحضاري الإسلامي، وكل ما بقي في أعماقهم هو أن الجانب التعبدي في الإسلام، بعيدا عن الدافعية الذاتية العلمية والحضارية، وبعيدا عن فهم ومعرفة ما أبدعه العلماء المسلمون قديما، وبنى عليه الغرب معرفته حديثا. وبعبارة أخرى، فإن الطالب المسلم صار غربيا متغربا، في هويته النفسية والحضارية، يقرأ تاريخ العلم وفق المنظور الغربي، وهذا بدأ في مرحلة الاستعمار، واستمر في حكومات ما بعد الاستعمار.
وحول هذا يقرّ بن نبي أن الاستعمار لجأ في بداية احتلاله لعالمنا العربي إلى القوة العسكرية، ثم تحوّل إلى نشر ثقافته، ثم عمل على امتصاص القوى الواعية في البلاد المستعمرة، بأية طريقة ممكنة، حتى لا تتعلق بفكرة مجردة، وسعى إلى تعبئتها بفكره وثقافته، ثم تولت مواقع القيادة في المنظومة التعليمية والعلمية في بلادها ([1])، وقد واصلت هذه الفئة المتغربة ما بدأه الاستعمار، بعد رحيله عن بلادنا، على صعيد التربية والهوية.
وإلى ذلك، يشير أبو يعرب المرزوقي إلى أزمة المنظومة التربوية العربية، بأنها نابعة من موقف الأمة الحضاري نفسه، الذي أصبح منحصرا في رد الفعل على المؤثرات الخارجية (الغربية)، التي حددت خصائص الفكر والعمل، دون الوعي بالمبدأ الكوني للإبداع، الذي تشترك فيه كل الحضارات الأصيلة، وقد أنتج هذا الموقف تبعية في المستويات الفكرية والمؤسسية، باتت تنحصر في محاكاة المؤثرات الأجنبية، أو التكرار المسرحي لماضينا الذاتي، الذي يتغنى بوحدة الأمة المسلمة، ويتناسون أن الأمة الإسلامية كانت قوتها الحقيقية سياسية وثقافية وعسكرية، مغلّفة بالوحدة الروحية، كما أن هناك حالة من سوء الفهم لنشأة وتكوّن العلوم النظرية والعملية وتطبيقاتهما في حضارتنا. وينادي المرزوقي بأهمية الاعتراف –بشجاعة- بأن كل تطور جدي في فكرنا وفعلنا ومؤسساتنا قد تميّز تميزا مطلقا بموقف انفعالي أمام المؤثرات الخارجية، وقليلا ما يجد المرء عملا ناتجا عن مؤثرات ذاتية، أي مؤثرات نابعة من البواعث الذاتية للإسلام، لأن هذه البواعث جُهِلَت أو أُهمِلَت، وصار الأمر تقليدا انفعاليا، يضاف له حالة التمزق القطري والقومي، وفقدان روح الأخوة الإسلامية، فالرفض المتلاحق لعلاج أمراض الأمة حضاريا، يؤدي إلى تخلخل وحدة الأمة الروحية والسياسية ([2]).
فما يطرحه المرزوقي يمثّل لّب الأزمة الحضارية الراهنة للمجتمعات المسلمة، والتي قد يختزلها البعض في غياب العلم والتقنية، أو الفساد والتراخي، ولكن الحقيقة أن العالم العربي والإسلامي تعامل مع الحضارة الغربية بروح انفعالية تراوحت بين التقليد الأعمى، أو اللجوء إلى ماض جميل متخيل، عنوانه وحدة المسلمين، بخطاب حماسي، غير مدرك لأسباب صعود الحضارة الإسلامية في الماضي، ولا مدرك لأسباب انحدارها في الحاضر، فالمسألة تخص ذات الأمة ونخبها وصنّاع القرار فيها.
ويرى المرزوقي أن الإسلام دين باعث للحضارة، وباعث للإصلاح المتواصل، وليس مجرد عبادات أو أقوال، أو قيم، وإنما هو دين عقائدي وعملي في آن، ويعطي مثالا على ذلك الفعل (جهد)، وفيه دلالتان: الأولى هي جوهر العقل النظري والعملي المطبقين، ألا وهو الجهاد، والثانية جوهر العقل النظري والعملي المجرّدين، ألا وهو الاجتهاد([3]). وقد تم تعطيل كلتا الدلالتين في الفكر العربي الحديث، الذي أغرق في الاقتباس من الفكر الغربي، مما أدى إلى تشرذم الأمة نفسيا، وفقدانها هويتها.
إن المنظومة التربوية العربية والإسلامية بحاجة إلى رؤية جديدة، تحدد بوصلتها، وتعيد تموضعها، وتصوغ استراتيجيتها، بعيدا عن الانفعالية، التي جعلتنا نعيش حالة من الاستلاب أمام الآخر الحضاري، والتردد أمام الذات والتراث.
وتمثّل الاستراتيجية مرجعية ونبراسا لصانع القرار، فهي بمثابة الأرضية المعرفية والفكرية التي يستند إليها، فأي عمل أو خطة أو برنامج، أو منظومة بلا استراتيجية، هي بمثابة طريق لا يُعرف بدايته، ولا يُعرف منتاه، ويمضي السائرون فيه بلا هدف، يبذلون الجهد، ولا يدركون لماذا بُذِل، ومن أين ابتدأ، وإلامَ ينتهي.
لذا، فمن تعريفات الاستراتيجية أنها “تمثّل خطوط سير، توصِلُ إلى هدف عام مشترك، حيث تنحصر مهمتها في تحديد وجهة السير، وتوضيح المسير، ومستلزمات السير، والمعنى فيه، وتكشف عن نوعية الصعوبات التي تواجهها، وتقدّم من المعالم البارزة؛ ما يمنع الانحراف بأيسر السبل وأحسنها، إلى غاية المسير” ([4]).
فقوام الاستراتيجية أنها تمتلك هدفا، وتحدد طرائق السير، وتضع قبل الهدف رؤية فكرية، واضحة المعالم، تضع الأمور في نصابها أمام صانع القرار، وواضع الخطط.
لذا، يشدد تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على أن الاستراتيجية في دلالتها العامة؛ هي مجموعة من الأفكار والمبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط الإنساني بصورة شاملة متكاملة، وترشد أيضا إلى وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات مساراته، بقصد إحداث تغيرات؛ وصولا إلى أهداف محددة ([5]).
وعندما نقرأ مفهوم الاستراتيجية في دائرة التربية، سنجد أنها تمثل الأرضية والمرجعية، التي تنبثق منها المناهج والمواد الدراسية، وتغلف برؤاها المعطيات العلمية والمعرفية، والقيم والاتجاهات، وتحدد البوصلة الصحيحة، لصانع القرار ومنفذه، وللمعلم، والمدير، وكل القائمين على المنظومة التربوية. فشتان ما بين الاستراتيجية، والتنظير الفكري والفلسفي، فالاستراتيجية فكر مؤطر، محدد، واضح المسار، أي يترجم التنظير الفكري، ويجعله قابلا للتطبيق، بأن يستلهم منه صانع القرار الرؤية والعمل.
والتربية الحضارية الإسلامية -وفق منظور مالك بن نبي– هي “جملة الجهود الفكرية والعملية التي تبذل في ميدان بناء الإنسان، لتوفير الشروط النفسية للبناء الحضاري، من خلال إعداد الفرد المسلم، وتهيئته لهذه الحالة، ففعل النهضة هو ما يبذل في الميدان النفسي، وهذا لن يتأتى إلا بتكوين الفرد الحامل لرسالة التاريخ أو إعداد الإنسان الجديد الذي يتسم بتركيب أصيل لعبقريته الإسلامية الخالصة، مع العبقرية الحديثة ([6]).
فرؤية بن نبي قوامها تكوين الفرد المسلم، المدرك لأبعاد رسالته الإيمانية، وتحقيق مفهوم الخلافة على الأرض، والذي يبيّنه عبد المجيد النجار بأن مهمة الإنسان الخليفة تتمثل في بذل همه وجهده في الاقتراب من الله مستخلفه، بالعمل الدائب، والكدح المستديم، لترقية ذاته، وتنميتها، حتى يبلغ من الاكتمال إلى الدرجة التي ترضي الله سبحانه ([7])، مصداقا لقوله تعالى: { يا أيُّها الإنْسانُ إنَّكَ كادِحٌ إلى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ }، (الانشقاق، 6). وهذا يتأتى بالسعي إلى تنمية الذات الإنسانية، وتكميلها بمنهاج العبادة، وأن يقوم المسلم بعمارة الأرض، واستثمار خيراتها، تحقيقا لقوله تعالى: { هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِیهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوۤا۟ إِلَیۡهِۚ إِنَّ رَبِّی قَرِیبࣱ مُّجِیبࣱ }، (هود، 61)؛ مدركا حقيقة التكليف الرباني، الذي حمّله الله سبحانه إياه، والذي يتوجب اضطلاع كل مسلم به، بأن يكون مؤمنا برسالته الربانية، غير جهول، ولا خاضع لشهواته، أو هواه. قال تعالى: { إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَیۡنَ أَن یَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَـٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومࣰا جَهُولࣰا }، (الأحزاب، 72).
فيتوجب على المسلم الترقي روحا، وعقلا، عطاء وعلما، كدا وسعيا، جهدا وتعميرا، متسلحا بالقيم الإسلامية، غير ساقط في وحل الظلم وسحق الإنسان ([8]).
من هنا، يتأسس مفهوم التربية الحضارية، الذي يعرّفه حسّان بأنه تأسيس معرفي، يتضمن العودة إلى الذات الحضارية المسلمة، ومكوناتها الأساسية، في مصادر التنظير الفلسفي التربوي، والمرجعية الفكرية الأصيلة لهذا التنظير، وأبعادها المعيارية، وقيمها المثالية، وضوابطها الواقعية، وخصائصها العالمية الإنسانية، والانفتاح على التراث، والإنتاج الإنساني في كل مراحله، لا سيّما الحضارة المعاصرة([9]).
ويضيف حسّان أن “التربية الحضارية في أحد جوانبها منهج فعّال بقصد تغيير الإنسان وتعليمه كيف يعيش مع أقرانه، وكيف يكوّن معهم مجموعة القوى التي تغيّر شرائط الوجود، نحو الأحسن دائما، وكيف يكوّن معهم شبكة العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ، أي تكوين بناء حضاري، أو الانتقال إلى مرحلة التحضر([10]).




